في إحدى ضواحي المدينة القديمة، حيث تختلط رائحة المطر برائحة الذكريات، كان سامي يعيش حياة بسيطة مليئة بالأحلام التي كانت كلها تتمحور حول فتاة واحدة فقط… مريم.
كانت مريم بالنسبة له كل شيء، لم يكن يراها فتاة عادية، بل كانت هي المعنى الحقيقي للحياة التي يحياها. عرفها منذ أيام الجامعة، حين تصادف أن جلس بجوارها في أول يوم دراسي، وتلك اللحظة كانت بداية قصة حب لم يعرف الزمان مثلها.كانت مريم فتاة هادئة، ملامحها تحمل شيئاً من الحزن الدفين رغم ابتسامتها الهادئة، وكان سامي يشعر أن خلف تلك النظرة الحزينة حكايات كثيرة لم تروَ بعد. مع مرور الأيام، أصبحا لا يفترقان، يجلسان في ساحة الجامعة يتحدثان عن أحلامهما، عن المستقبل الذي يتمنيان أن يجمعهما، وعن البيت الصغير الذي وعدها سامي أن يبنيه لها على تلة مرتفعة تطل على البحر.
مرت السنوات، وتخرج الاثنان. بدأ سامي في البحث عن عمل، وواجه الصعوبات الكثيرة التي يعانيها كل شاب يحاول أن يبدأ من الصفر، بينما مريم كانت تنتظر، تراقبه بصمت، تؤمن به أكثر من إيمانها بنفسها. كانت تقول له دائمًا:
"أنا أثق فيك، حتى وإن تأخرنا، المهم أننا سنصل سويًا."
وكان يبتسم لها دائمًا ويقول:
"لن أتخلى عنك مهما حدث، أنتِ البداية والنهاية، يا مريم."
لكن الحياة، كما هي دائمًا، لا تمنحنا ما نريد بسهولة.
بدأت الضغوط تزداد حول مريم من كل جانب، فأسرتها كانت ترى أن الوقت يمضي،
وأنه لا يجوز أن تبقى دون زواج. كانت أمها تخشى كلام الناس، وأبيها يرى أن
سامي غير مستقر ولا يملك شيئًا.
كانت مريم تبكي في غرفتها كل ليلة، تبكي لأنها لا تستطيع أن تشرح لهم أن
الحب ليس مالاً، ولا بيتًا فخمًا، بل هو دفء الروح وصدق المشاعر.
في أحد الأيام، جاءها والدها وهو يحمل وجهًا صارمًا وقال لها:
"مريم، لقد جاءنا اليوم ابن عمك خالد يطلب يدك، ولن أرفض له طلبًا، إنه رجل محترم، ووضعه ممتاز، ولن نجد أفضل منه لك."
تجمدت
الكلمات على شفتيها، شعرت أن الأرض تميد من تحتها، أرادت أن تصرخ، أن تقول
لا، لكن الخوف من خيبة الأمل في عيون والدها جعلها تصمت.
تسللت دمعة حارة على خدها وقالت بصوت متحشرج:
"لكن يا أبي… أنا… أحب سامي."
نظر إليها والدها بحدة وقال:
"الحب لا يبني بيتًا يا مريم، المال والاستقرار هما ما يبنيان الحياة، سامي مجرد شاب فقير، سيضيعك معه."
تلك الليلة لم تنم مريم، جلست تحدق في صورها مع سامي، تلك الصور التي كانت تحفظها في هاتفها وكأنها كنز.
كانت تتذكر ضحكته، صوته، كلماته، ووعوده التي ملأت قلبها بالأمل.
وفي الصباح، قررت أن تلتقي به لتخبره بما يحدث.
جلست
في المقهى الذي اعتادا أن يلتقيا فيه، يداها ترتجفان، وقلبها يكاد ينفجر
من الخوف. جاء سامي مبتسمًا، كالعادة، لكن ابتسامته اختفت حين رأى وجهها
الشاحب وعيونها الممتلئة بالدموع.
جلس أمامها وقال:
"ماذا هناك يا مريم؟ ما بكِ؟"
لم تستطع أن تنطق، ظلت تنظر إليه بصمت، فمد يده إليها قائلاً:
"تكلمي، أنتِ تخيفينني."
قالت بصوت خافت:
"أبي يريد أن يزوجني من ابن عمي… لا أستطيع رفضه… إنهم يضغطون عليّ كل يوم."
وقف سامي فجأة من مكانه، نظر إليها غير مصدق، وكأنه تلقى طعنة في صدره، وقال بصوت مرتجف:
"وما الذي تريدينه أنتِ يا مريم؟ هل تريدين الزواج منه؟"
نظرت إليه وهي تبكي وقالت:
"أنا لا أريده، لكني لا أستطيع أن أؤذي أبي، هو مريض، وغضبه عليّ قد يقتله… سامي، صدقني لو كان الأمر بيدي، لما تركتك لحظة واحدة."
جلس سامي مرة أخرى، لكنه كان يشعر وكأن كل شيء انهار بداخله، كأن العالم توقف عن الدوران.
أمسك بيدها وقال بصوت حزين:
"كنت أظن أن الحب يستطيع أن يتحدى كل شيء، لكن يبدو أنني كنت واهمًا…"
رحلت مريم في تلك اللحظة، وتركته يجلس وحده، ينظر إلى الطاولة التي كانت تجمعهما دائمًا.
ومنذ ذلك اليوم، لم يعد سامي كما كان.
مرت الأيام، وتزوجت مريم بالفعل من ابن عمها خالد، كان رجلًا طيبًا في الظاهر، لكنه لم يكن سامي.
عاشت معه بجسدٍ لا قلب له، تؤدي دور الزوجة أمام الجميع، لكنها في الداخل كانت فارغة تمامًا.
كلما سمعت صوته يناديها باسمها، كانت تتذكر سامي وهو ينطق اسمها بخفةٍ ودفءٍ لا يشبه أحدًا.
كانت تستيقظ كل صباح وهي تتساءل:
"هل يشعر سامي بما أشعر به الآن؟ هل ما زال يذكرني؟"
أما سامي، فقد تغير تمامًا.
ترك عمله، وانعزل عن الجميع.
كان يقضي أيامه في المشي بلا هدف، يحمل في جيبه صورة قديمة لهما، ينظر إليها كلما اشتد عليه الحنين.
لم يعد يضحك، ولم يعد يتحدث كثيرًا، أصبح كجسدٍ بلا روح، يعيش فقط لأن الموت لم يأتِ بعد.
وفي
ليلة ممطرة، عاد سامي إلى المكان الذي كانا يجلسان فيه دائمًا، جلس في نفس
الطاولة، طلب قهوته كما كان يفعل، وأخرج الصورة من جيبه ووضعها أمامه.
نظر إلى السماء وقال:
"أتعلمين يا مريم؟ ما زلت أراكِ في كل شيء… في المطر، في ضوء الصباح، في كل امرأة تمر أمامي.
لكن لا أحد يشبهك، لا أحد."
كان المقهى شبه فارغ، إلا من بضع زبائن يهمسون، وهدير المطر على الزجاج.
جلس سامي هناك لساعات طويلة، حتى أغمض عينيه وترك رأسه يسقط على الطاولة.
لم ينتبه أحد في البداية، لكن حين اقترب النادل، وجده ساكنًا، بلا حراك.
رحل سامي في تلك الليلة بهدوء، كأنه قرر أن يلحق بمحبوبته إلى عالم آخر لا ظلم فيه، ولا فراق.
أما مريم، فقد علمت بخبر وفاته بعد أيام.
كانت تقف أمام المرآة حين أخبرها أحد أقاربها، سقطت المرآة من يدها وتحطمت، كما تحطم قلبها من قبل.
جلست على الأرض تبكي بصوتٍ مكتوم، حتى فقدت وعيها.
منذ ذلك اليوم، لم تعد مريم كما كانت.
لم تعد تضحك، ولم تعد تهتم بأي شيء.
كانت تعيش مع زوجها، لكنها لم تكن حقًا هناك، جسد فقط، يتحرك في الحياة دون أن يشعر بها.
كانت تجلس في الشرفة كل مساء تنظر إلى السماء، تتحدث مع النجوم كأنها تتحدث مع سامي.
تقول له بصوتٍ مبحوح:
"هل وجدت الراحة يا سامي؟ هل نسيتني؟
أنا لم أنسك… ما زلت أعيش بك، حتى وأنا بين الناس."
مرت السنوات، ومريم أصبحت شاحبة، هزيلة، كأن الحياة تسحب منها ببطء كل بريقٍ كان يسكنها.
وفي ليلةٍ باردة، كانت تمطر بغزارة، جلست مريم بجوار النافذة، تمسك بالصورة القديمة التي احتفظت بها رغم كل شيء.
ابتسمت بصعوبة، وقالت بصوتٍ خافت:
"ها أنا أراك من جديد… سامي، انتظرني قليلاً فقط."
في الصباح، وجدوها ساكنة، ملامحها هادئة، وابتسامة صغيرة على وجهها، وبجانبها الصورة التي جمعتها ذات يوم مع سامي.
رحلت مريم كما رحل هو… إلى نفس النهاية، إلى نفس الصمت الأبدي.
لم يكن أحد يدرك أن الحب يمكن أن يقتل ببطء، أن يجعل الإنسان يعيش وهو ميت في داخله.
لقد كانت قصتهما درسًا قاسيًا في أن الضغط العائلي قد يقتل قلوبًا صادقة، وأن الفراق لا يميت الجسد فقط، بل يميت الروح أيضًا.
وهكذا انتهت قصة سامي ومريم، لا بل لم تنتهِ… لأنها بقيت محفورة في الذاكرة كأجمل وأوجع قصة حب لم تكتمل، قصة لم يكتبها القدر بالنهاية السعيدة، بل كتبها بالدموع والرحيل.

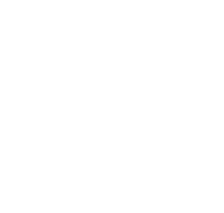

تفضلوا بزيارتنا بانتظام للاستمتاع بقراءة القصص الجديدة والمثيرة، ولا تترددوا في مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا.